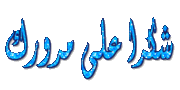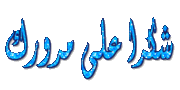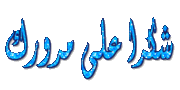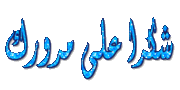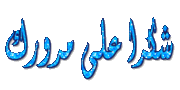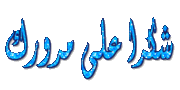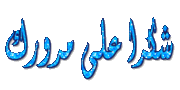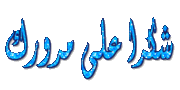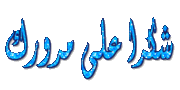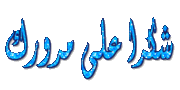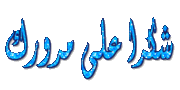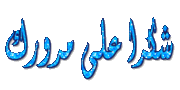
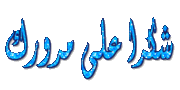
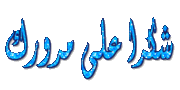
بر الإيمان للقديس كيرلس الكبير عمود الدين
+ «فقال للمرأة: إيمانك قد خلَّصكِ، اذهبي بسلام» (لو 7: 50).
«يا جميع الأُمم صفقوا بأيديكم، هلِّلوا لله بصوت الحمد» (مز 47: 1)؛ ذلك لأن المخلِّص قد أعدَّ لنا طريقاً جديداً للخلاص لم يطأه القدماء.
فالناموس الذي رسمه موسى الكلِّي الحكمة كان لاستنكار الخطية وإدانة التعدِّيات، ولكنه لم يُبرِّر أحداً على الإطلاق. وها الفائق الحكمة بولس يكتب قائلاً: «مَن خالف ناموس موسى، فعلى شاهدَيْن أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة» (عب 10: 2.
ولكن ربنا يسوع المسيح بعد أن أزال لعنة الناموس، وأكَّد على عجز وعدم فاعلية الوصية التي تدين، صار رئيس كهنتنا الأعظم حسب قول المغبوط بولس (عب 6: 20)، لأنه صار يُبرِّر الفاجر بالإيمان، ويُطلِق أسرى الخطية أحراراً، وهذا ما قد سبق وأعلنه لنا على فم أحد أنبيائه القديسين: «في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب: يُطْلَب إثم إسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد، لأني أغفر لِمَن أُبقيه» (إر 50: 20).
أما تحقيق هذا الوعد فقد صار لنا عند تجسُّده، كما تؤكِّد لنا الأناجيل المقدسة. فعندما دعاه أحد الفرِّيسيين، ولكونه ودوداً ومُحبّاً للإنسان ومُريداً أنَّ «كل الناس يخلصون، وإلى معرفة الحق يُقبلون» (1تي 2: 4)، لبَّى رغبة الداعي وحقَّق له أُمنيته. وإذ دخل إلى عنده واتَّكأ على مائدته، للوقت دخلت امرأة تلطَّخت حياتها بالعيوب المشينة. وكمَن أفاق بصعوبة من الخمر والسُّكر، هكذا بدأت هي تحس بتعدِّياتها، وقدَّمت توسُّلاتها إلى المسيح كقادرٍ على تطهيرها وتخليصها من كل عيبها، وتحريرها من كل خطاياها السابقة
”كصفوح عن الآثام وغير ذاكر للخطايا“ (عب 8: 12). وإذ تجرَّأت على الاقتراب إليه، غسلت رجليه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها، ثم أيضاً دهنتهما بالطِّيب.
وهكذا نجد أن امرأة كانت من قبل خاطئة ومنغمسة في الخطية، لا تخفق في أن تجد سبيل الخلاص، لأنها لجأت لِمَن يعرف كيف يُخلِّص، وله القدرة أن يرفع من أعماق النجاسة. فهي، إذن، لم تُخذَل في تحقيق غايتها.
أما الفرِّيسي الجاهل، فيُخبرنا عنه الإنجيل المبارك أنه أُعثر وقال في نفسه: «لو كان هذا نبياً لَعَلِمَ مَن هذه الامرأة التي تلمسه وما هي! إنها خاطئة» (لو 7: 39). فالفرِّيسي كان معتزّاً بنفسه وعديم الفهم تماماً؛ إذ كان أحرى به أن يضبط هو حياته الخاصة ويُزيِّنها جدِّياً بكل الجهادات الفاضلة، لا أن يحكم على الضعفاء ويدين الآخرين.
ولكننا، إذ نلتمس له العذر، نقول إنه نشأ على عوائد الناموس وأخضع نفسه لسلطانه ومتطلباته إلى أبعد حدٍّ، فأراد بدوره أن يُلزِم رب الشريعة نفسه بأن يخضع لأوامر ونواميس موسى، لأن الناموس أمر بحفظ المُقدَّس نفسه بعيداً عن النجس؛ بل إن الله أيضاً لام رؤساء الشعب اليهودي بسبب مخالفتهم هذا الأمر. فقد تكلَّم على فم أحد أنبيائه القديسين قائلاً: «لم يميِّزوا بين المُقدَّس والنجس» (حز 22: 26)؛ إلاَّ أن المسيح أتى لأجلنا، لا ليُخضعنا للعنات أحكام الناموس، بل ليفتدي أولئك الخاضعين للخطية برحمة فائقة على الناموس،
فالناموس وُضِعَ «بسبب التعدِّيات»، كما يُصرِّح الكتاب: «لكي يستدَّ كل فم، ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرَّر أمامه» (رو 3: 20،19؛ غل 3: 11). لأنه ما من أحدٍ بلغ حدّاً في القوة، أعني من القوة الروحية، بحيث أمكنه أن يُتمِّم كل ما أُمِرَ به وصار بلا لوم. أما النعمة التي صارت لنا بالمسيح، فهي تُبرِّر، وإذ أَلغَت حُكْم الناموس الواقع علينا، حررتنا بواسطة الإيمان.
فذلك الفرِّيسي المغرور الجاهل لم يَرَ في يسوع أنه قد وصل حتى إلى مستوى نبي؛ أما الرب فقد اتخذ من دموع المرأة فرصة لكي يكشف له عن السرِّ أي طريق الخلاص. فهو يُلمِّح للفرِّيسي ولكل المجتمعين في بيته أنه: لكونه كلمة الله أتى إلى العالم في شبهنا لا «ليدين العالم بل ليَخْلُصَ ”به“ العالم» (يو 3: 17). إنه أتى ليعفو عن المديونين بالكثير أو بالقليل، ويُظهِر رحمته للصغير والكبير، حتى لا يحرم أي واحد، مهما كان، من المشاركة في جُوده. وكدليل ومَثلٍ واضح لنعمته، فقد عفى عن هذه المرأة غير المتعففة وحرَّرها من آثامها
العديدة بقوله: «مغفورة لكِ خطاياكِ». وإنه جدير بالله حقاً أن يُصرِّح بمثل هذا القول! إنها كلمة مصحوبة بسلطان علوي. لأنه إذا كان الناموس قد أدان الواقعين في مثل هذه الخطايا، فمَن هو يا تُرى القادر أن يحكم بأمور تعلو على الناموس إلاَّ ذاك فقط الذي سَنَّه؟!
فالرب في نفس الوقت، حرَّر المرأة من أوزارها، ثم وجَّه نظر الفرِّيسي ومَن كانوا مدعوين معه إلى أمورٍ أسمى، حتى يُدركوا أن الكلمة ”الكائن إلهاً“ ليس هو كواحدٍ من الأنبياء، بل هو يفوق حدَّ البشرية بما لا يُقاس، حتى بالرغم من أنه قد صار إنساناً.
ويمكننا أن نقول لمَن دعا الرب: لقد تثقَّفتَ أيها الفرِّيسي بالأسفار المقدسة، والمفروض بطبيعة الحال أنك تعرف الوصايا المُعطاة على يد موسى عظيم الحكماء، وقد درستَ أقوال الأنبياء؛ فمَن ذاك، إذن، الذي سلك طريقاً متعارضاً مع الناموس وحرَّر الآخرين من المعصية؟ مَن نادى بتحرير مَن تجاسر وكسر علانية الأوامر الموضوعة؟ فتعرَّف، إذن، بمتابعة الحقائق ذاتها على الواحد الذي هو أعلى من الأنبياء والناموس، واذكر أن واحداً من الأنبياء القديسين قد أعلن عنه هذه الأمور قديماً عندما قال: «مَن هو إلهٌ مثلك غافر
الإثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه. لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يُسرُّ بالرأفة» (ميخا 7: 1.
لذا فقد تعجَّب واندهش أولئك المتكئون على مائدة الفرِّيسي في رؤيتهم للمسيح مخلِّص الجميع حائزاً على مثل ذلك السلطان الإلهي، ومستخدماً تعبيرات ليست من حق الإنسان البشري، ومِن ثمَّ قالوا: «مَن هو هذا الذي يغفر الخطايا أيضاً»؟ أترغب في أن أُخبرك: مَن هو؟ إنه ذاك الكائن في حضن الله الآب، والمولود من طبيعته الجوهرية، الذي به صار كل شيء إلى الوجود، صاحب السلطان العلوي، وله يخضع كل ما في السماء وما على الأرض. إلاَّ أنه اتخذ لنفسه هيئتنا، وصار رئيس كهنتنا الأعظم حتى يُقدِّمنا لله أطهاراً بلا عيب، فنخلع
الطبيعة العليلة التي للخطية ونلبسه هو كطبيعة ذات رائحة ذكية، حيث يقول بولس الرسول ذو الحكمة العالية: «نحن رائحة المسيح الذكية لله» (2كو 2: 15). وهو الذي تكلَّم على فم النبي حزقيال قائلاً: «وأنا أكون لكم إلهاً وأُخلِّصكم من كل نجاساتكم» (حز 36: 29،2. وهوذا التتميم الفعلي لِمَا قد وُعِدَ به قبلاً بواسطة الأنبياء القديسين. فاعترفْ به إلهاً وديعاً ومتعطِّفاً على البشر. امسك بطريق الخلاص. اهرب لحياتك من الناموس الذي يقتل، واقبل الإيمان الذي هو أسمى من الناموس. فقد قيل إن «الحرف يقتل»، أي أن الناموس يحكم بالموت، «أما الروح فهو يُحيي» (2كو 3:
6)، أي أن التطهير الروحي الذي بالمسيح يهب الحياة الأبدية.
لقد ربط الشيطان أهل الأرض بحبال الإثم؛ أما المسيح فقد فكَّهم من عقالهم. إنه قد صيَّرنا أحراراً، وأبطل طغيان الخطية، وأبعد المشتكي على ضعفاتنا. وهكذا تمَّ قول الكتاب: «كل إثم سيسد فاه» لأن «الله هو الذي يُبرِّر» و«هو الذي يدين» (مز 106: 42؛ رو 8: 33). وهكذا يتم ما يرجوه صاحب المزمور الملهم بالوحي الإلهي عندما يُناجي المسيح مُخلِّص الجميع قائلاً: «لتُبَد الخطاة من الأرض، والأشرار لا يكونوا بعد» (مز 104: 35)، لأنه لا يُعقل أن نقول عن إنسانٍ مُلهم بالروح إنه يلعن الضعفاء الخاطئين، فلا يليق بالقديسين أن يلعنوا
إنساناً أيّاً كان، وإنما يرجو ذلك من الله؛ لأنه قبل مجيء المخلِّص كنَّا جميعاً تحت سلطان الخطية، ولم يكن واحدٌ قد عرف ذاك الذي هو بالطبيعة والحق إله: «الجميع زاغوا وفسدوا معاً. ليس مَن يعمل صلاحاً، ليس ولا واحد» (رو 3: 12). ولكن لأن الابن الوحيد الجنس (مونوجينيس) أخلى ذاته وتجسَّد وتأنَّس (أي صار إنساناً)، فقد باد الخطاة ولم يوجدوا بعد (أي أزال سلطان الخطية من على الإنسان، فلم يَعُد عبداً أسيراً للخطية)، لأن القاطنين على الأرض قد تبرَّروا بالإيمان، واغتسلوا من دنس الخطية بالمعمودية المقدسة، وصاروا شركاء الروح القدس، بعد أن تحرَّروا
من يد العدو، وكأنهم أَجْبروا فلول الشياطين أن يهربوا ليظلُّوا هم تحت نير المسيح.
فهبات المسيح تصعد بالبشر إلى قمة الرجاء الذي طالما انتظروه، وإلى أبهج الأفراح.
فها المرأة التي كانت مُلطَّخة بأدناسٍ عديدة، ومستحقة لكل ملامة بسبب أفعالها الشائنة، تتبرر، حتى يكون لنا نحن أيضاً ثقة أكيدة بأن المسيح سيرأف بنا عندما يرانا مُقبلين إليه، جاهدين أن نفلت من أشراك الإثم.
لنَمثُل أمامه نحن أيضاً، ولنذرف دموع التوبة. لندهنْه بالطيب، لأن دموع التائب هي رائحة ذكية لدى الله. واذكر مَن قال: «اصحوا أيها السكارى، وابكوا وولولوا يا جميع شاربي الخمر» (يوئيل 1: 5)، لأن الشيطان يُسكِر القلب ويُهيِّج العقل باللذة الخاطئة، دافعاً الناس إلى الانغماس في مهاوي الشهوات الحسية.
ولكن ما دام لنا وقت، فلنستيقظْ، وكما يقول الفائق الحكمة بولس: «فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. لنسلك بلياقة كما في النهار، لا بالبَطَر (أي اللهو والاستخفاف بالنعمة) والسُّكر، لا بالمضاجع والعَهَر...» (رو 13: 13،12)، «جميعكم أبناء نور وأبناء نهار. لسنا من ليل ولا ظلمة» (1تس 5: 5).
لا تضطرب إذا ما تفكَّرتَ في جسامة خطاياك السالفة؛ بل اعلم تماماً، أن النعمة ما زالت تفوقها عِظَماً، فهي الكفيلة بأن تُبرِّر الأثيم وتغفر ذنوب الفاجر.
فالإيمان بالمسيح هـو ضامن لنا بكل هذه البركات العظيمة، لأنه الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، ويدعونا للانطلاق إلى المنازل العلوية، ويرقَى بنا لميراث القديسين، ويجعلنا أعضاء في ملكوت المسيح، الذي به وله مع الله الآب ومع الروح القدس، المجد والسلطان إلى أبد الآباد آمين. +
م ن ق و ل عن موقع مجلة مرقس